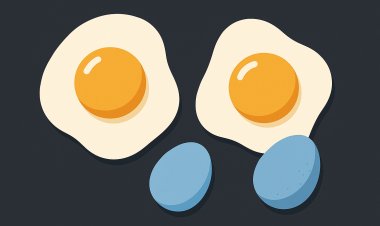حين تتأخر الترقية: فلسفة الصعود الوظيفي خارج منطق الترقية التقليدية
هنا نعالج بعمق تأخر الترقية والصعود الوظيفي، عبر تحليل نفسي واستراتيجي لجدوى التنقل العرضي، وإعادة تعريف النجاح، والتخطيط الذكي للوصول إلى المناصب الأعلى داخل المؤسسة أو خارجها.

حين يتأخر الصعود – فضيلة التنقل العرضي في عالم العمل
ليس أقسى على النفس من أن ترى من حولك يصعدون، وأنت واقف في ذات الدرجة، لا تسقط، لكنك لا ترتفع. تتساءل: ماذا ينقصني؟ أهو الحظ؟ أم أن شيئًا فيّ لا يُرى؟ لكن غالبًا ما يكون السؤال الحقيقي مختلفًا: هل كنت أبحث عن الترقية، أم عن النمو؟ وهل حقًا أعرف الفرق بينهما؟
في عالم المؤسسات، يُختزل النجاح غالبًا في مفهوم الترقية الرأسية – منصب أعلى، صلاحيات أكبر، دخل أوفر. لكنها نظرة تختزل الإنسان في المسار، دون أن تتأمل في عمق الرحلة. فليست كل حركة إلى أعلى تعني تقدمًا، كما أن الثبات الظاهري لا يعني بالضرورة جمودًا.
التنقل العرضي: النمو دون صعود
التنقل العرضي – وهو الانتقال بين أقسام أو أدوار مختلفة داخل المنظمة أو حتى إلى منظمات أخرى بنفس الدرجة الوظيفية – لا يُنظر إليه كثيرًا كترقية، لكنه في الحقيقة أحد أعمق أشكال التطور المهني.
ففي كل انتقال عرضي تُعاد صياغة العلاقة بين الفرد والمعرفة، بينه وبين النظام، بينه وبين ذاته. تتجدد الأسئلة، وتتغير التحديات، وتُكسر الرتابة التي قد تُميت حتى أكثر العقول حيوية.
إن الموظف الذي انتقل من التسويق إلى العمليات، أو من القطاع الخاص إلى قطاع حكومي، لم يصعد درجة، لكنه وسّع خارطة فهمه، أضاف طبقة جديدة إلى وعيه المهني، وتحول من "خبير موضعي" إلى "قارئ شامل للمنظومة".
البقاء في المربع ذاته لا يعني الثبات
في كثير من الأحيان، تكون الترقية الرأسية الممنوحة في وقت مبكر، قاتلة للوعي. إذ يحصل الفرد على السلطة قبل أن يملك البصيرة، فيصبح أسير منصب لا يفهم عمقه، ولا يدرك تاريخه ولا يرى نتائجه.
أما من اختار التنقل الأفقي، أو قَبِل به وهو يراه مرحلة لا هزيمة، فهو يُنضج ذاته، ويؤسس لما هو أعمق من مجرد ترقية: سمعة عقلية، ومرونة فكرية، وشبكة علاقات واسعة، ونظرة استراتيجية لا تتحقق في المسارات المستقيمة.
المؤسسة الذكية تلتقط المتحركين عرضيًا
المفارقة أن أكثر من يصعدون في وقت لاحق هم من كانوا الأكثر حركة في المراحل الأولى، لا لأنهم ركضوا باتجاه الهدف، بل لأنهم تحركوا باتجاه الفهم. فالمؤسسة الذكية لا تصعد من يسير في خط مستقيم فقط، بل من اتسعت رؤيته بفعل تنوع المواقع.
والموظف الذي ذاق طعم اختلاف البيئات، هو الأقدر على القيادة؛ لأنه لا يُفكّر فقط من موقعه، بل من مجموع المواقع التي مر بها.
تأخر الترقية... أم تأخر الفهم؟
هل تأخرتَ، أم أنك تسير وحدك في مسارٍ آخر؟
حينما لا تأتي الترقية في وقتها "المفترض"، يبدأ الإنسان بسلسلة من الأسئلة القاتلة: لماذا لستُ على القائمة؟ ما الذي ينقصني؟ كيف صعد فلان وبقيت أنا؟
لكن السؤال الصحيح ليس عن "الترقية" بحد ذاتها، بل عن معاييرها، وعن منطقها، وعن المعنى الذي منحناه لها دون مراجعة.
إن الألم الحقيقي لا ينبع من تأخر الترقية، بل من ظنّنا أنها المعيار الوحيد للتقدير. وفي ذلك اختزال للذات، وتفويض غير معلن للمنظمة كي تحدد لنا قيمتنا.
1. إعادة تعريف النجاح: من المرتبة إلى الأثر
الترقيات تعني الكثير في ثقافة المؤسسات، لكنها لا تعني كل شيء. فالأثر الذي يصنعه الإنسان داخل المنظمة – من حيث التأثير، والتعليم، والمبادرة، وبناء العلاقات – هو رأس مال لا يظهر في هيكل الرواتب، لكنه يُصنع به المستقبل.
القيمة الشخصية لا تُمنح، بل تُبنى. ومن يبني نفسه ليكون مرجعًا، ومصدرًا، وحلقة وصل بين الأفكار، لن يستطيع أحدٌ أن يضعه في خانة النسيان، حتى لو تأخرت الترقية الرسمية.
2. الوعي النفسي: من رد الفعل إلى هندسة الذات
يتعامل كثيرون مع تأخر الترقية كنوع من "الرفض المؤسسي"، ويقعون في فخ المقارنة المسمومة، أو التذمر الخفي. هذه الحالة، وإن بدت إنسانية، تخلق سلوكًا دفاعيًا ينتهي بصاحبها إلى العزلة أو التوتر أو "العمل الصامت".
لكن من يفهم أن الترقية قرار تنظيمي – أحيانًا عادل، وأحيانًا لا– يدرك أن قيمته لا تتحدد بها، بل بما يبنيه داخل نفسه. ومن هنا يبدأ استثمار التأخر كفرصة: لتعميق المهارات، لتوسيع دائرة التأثير، أو حتى لإعادة تقييم المسار كله.
3. النفوذ غير الرسمي: سلطة الأثر لا المنصب
في كثير من المؤسسات، هناك أشخاص لا يحملون ألقابًا كبرى، لكن الجميع يعود إليهم. يُستشارون، يُحترمون، يُعوّل عليهم. هؤلاء بنوا نفوذًا لا يعتمد على ترقية، بل على خبرة، وعقل، وخلق، وعلاقات.
القيمة المهنية لا تُختزل في سلمٍ إداري، بل تُبنى على قاعدة "من تكون" لا "ماذا تملك من مسمى وظيفي". وإن كانت المؤسسات تُبطئ أحيانًا في منح الترقية، فإن الحياة لا تبطئ في منح من يستحق.
حين تصبح الترقية خيارًا استراتيجيًا لا مصادفة
مقدمة: السلم لا يُصعد، بل يُبنى خطوة بخطوة
في ممرات المؤسسات، وعلى أطراف الاجتماعات، تتردد عبارة واحدة كثيرًا: "فلان ترقّى!" لكننا نادراً ما نتوقف لسؤال: هل ترقّى لأن النظام أنصفه؟ أم لأنه خطط لنفسه؟
في عالم لا يعترف بالأحلام غير الممنهجة، يصبح التخطيط الاستراتيجي للصعود المهني ضرورة، لا رفاهية. فالنجاح لم يعد نتاجًا للمثابرة فقط، بل للذكاء في التموضع، والفهم العميق لطبيعة الأنظمة التي نحيا داخلها.
1. التخطيط الاستراتيجي كوسيلة لبناء مسار وظيفي صاعد
الترقية، على عكس ما يُظن، ليست وعدًا زمنياً تُصدره الإدارة بعد كل عدد من السنوات، بل هي غالبًا نتيجة لمدى وضوحك في بناء ملفك المهني: المهارات، العلاقات، الإنجازات، ونقاط التأثير.
التخطيط الاستراتيجي هنا يعني أن تسأل: ما الموقع الذي أريد الوصول إليه؟ وما المهارات التي يحتاجها؟ من يملك القرار؟ ما الأنظمة التي تحكم هذا الهيكل؟
ثم تبدأ بإعادة تشكيل وقتك وسلوكك وشبكة علاقاتك نحو هذا الهدف. لا بانتظار فرصة، بل بصناعة مناخ مهني لا تستطيع المنظمة تجاهلك فيه.
2. بين البقاء والتقدم: متى يكون الانتقال هو الترقية الحقيقية؟
في بعض الأحيان، يكون سقفك في المنظمة الحالية منخفضًا. لا لأنك لا تستحق، بل لأن السياسات الداخلية أو شح الفرص لا يخدمان طموحك. هنا يصبح البحث عن وظيفة خارجية بمنصب أعلى قرارًا استراتيجيًا، لا خيانة للمكان.
الانتقال المدروس إلى منظمة تمنحك مجالًا أكبر للتأثير، أو مكانًا أقرب لرؤيتك، هو شكل راقٍ من أشكال التخطيط الاستراتيجي الشخصي. المهم ألا يكون القرار رد فعل عاطفي، بل نتيجة تحليل دقيق للفرص، والقيم، والبيئة الجديدة.
3. بناء الترقية قبل طلبها
المنصب يُمنح غالبًا لمن "يُمارسه" قبل أن يُعيَّن فيه. ومن يفكر استراتيجيًا، لا ينتظر الترقية ليبدأ أداءً نوعيًا، بل يخلق واقعًا يجبر الإدارة على أن تترجم أثره إلى مسمى رسمي.
مارس المسؤولية قبل أن تُطلب منك. شارك في الملفات الكبرى، كن حاضرًا في التحديات، واطلب التغذية الراجعة باستمرار. فالمؤسسة لا تُرقّي الأصوات العالية، بل الأثر العميق.